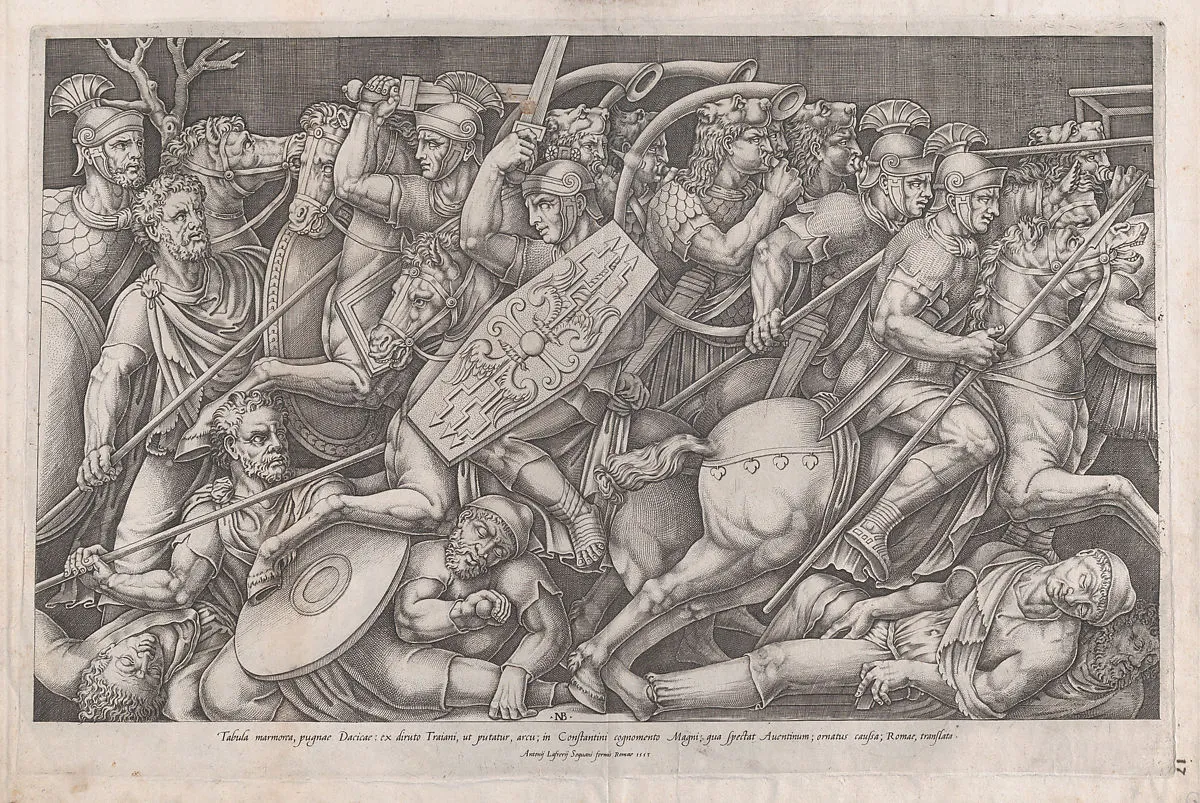لما كتبت الصفحات الآتية -أو بالأحرى الجزء الأعظم منها- كنت أعيش وحدي في الغابات على بعد ميلٍ من أي جارٍ لي، في بيتٍ أنشأته بنفسي على شاطئ بحيرة والدن، في بلدة كونكورد[1] من أعمال ولاية ماساتشوستس[2] وقضيت فيه سنتين وشهرين كنت أعيش فيهما من عمل يدي وحدهما، أما الآن فهأنذا من جديدٍ عابر سبيلٍ في حياة المدنية والحضارة.
لم يكن لي أن أضايق قرائي بالإكثار من عرض شؤوني الخاصة عليهم لو لم يقم أهل بلدتي ببحوث خاصة يتقصون بها أحوالي، ويتعرفون بها على طريقة معيشتي، فكانت بحوثٌ عدها بعضُهم من قبيل الفضول، ولكنها لا تبدو لي كذلك، بل إني لأعدها طبيعية جدًّا، وفي موضعها بسبب ظروف معيشتي تلك. فقد سأل بعضهم عما آكله وعما إن كنت أشعر بالوحشة، وإن لم أكن خائفًا وما إلى ذلك. وقد بلغ الفضول بجماعةٍ منهم أن أرادوا أن يعرفوا مقدار ما خصصته من دخلي للأعمال الخيرية، وسأل بعض ذوي الأسر الكبيرة عن عدد الأطفال الذين أعولهم وأنفق عليهم. وعلى هذا أرجو من قرائي الذين لا يهتمون بشؤوني اهتمامًا خاصًّا أن يصفحوا عني إذا ما أجبت عن بعض هذه الأسئلة في هذا الكتاب.
ففي بعض الكتب يحذف عادةً ضمير المتكلم (أنا) أي ضمير الشخص الأول، ولكني سأحتفظ به في كتابي هذا وذلك هو الفرق الأساسي من حيث تحدث المرء عن نفسه، فإنَّا لننسى عادة أن الشخص الأول هذا هو قبل كل شيء الذي يتكلم ويتحدث دائمًا، وما كنت لأكثر الكلام عن نفسي إن كان ثمة شخص آخر غيري أعرفه مثل هذه المعرفة الوثيقة، ولذا فإني -لسوء الحظ- سأقتصر هنا على هذا الموضوع لقلة خبرتي بغيري من الناس.
وزيادة على ذلك فإني أطلب من كل كاتبٍ أولًا -أو آخرًا إن شئت- أن يقص علينا سيرته الخاصة في إخلاصٍ وبساطة لا ما سمعه عن حياة غيره من الناس فحسب. أطلب منه أن يسرد علينا شيئًا مما يكتبه عن نفسه من بلادٍ نائية إلى قريب له، فإنه إن عاش مخلصًا حقًّا فلا بد -في رأيي- أن يكون قد عاش في أرضٍ بعيدةٍ عني كل البعد. ولعل المقصود بهذه الصفحات هم الفقراء من الطلبة بوجهٍ خاصٍّ، أما سائر قرائي فعليهم أن يقنعوا بما يصدق عليهم منها، وأرجو ألَّا أحد يعمد منهم وهو يرتدي هذه الحلة إلى استعمال العنف عند لبسها، فيفتق دروزها ويتلفها، فلعلها تفيد من تلائمهم وتصلح لهم فائدةً كبيرة.
إني أود أن أقول شيئًا هنا لا يخص الصينيين وسكان جزائر ساندويتش[3] بقدر ما يخصكم أنتم يا قراء هذه الصفحات الذين يقال عنكم أنكم تعيشون في إقليم نيو إنجلند[4] فسأذكر شيئًا عن أحوالكم ولا سيَّما الظاهرية منها، فأحدثكم عن ظروفكم في هذه الدنيا، وفي هذه البلدة ذاتها. فما هي هذه الأحوال يا ترى؟ وهل من الضروري أن تكون من السوء بالقدر الذي هي عليه؟ وهل من الميسور أن تنصلح وتتحسن؟ لقد طفت كثيرًا أنحاء بلدة كونكورد، وكنت حيثما سرتُ أجد السكان في كل مكان؛ في المتاجر وفي المكاتب والحقول يبدون جميعًا كأنهم يكفرون عما اقترفوه من ذنوبٍ وآثام.
يكفرون عنها بآلافٍ من الطرق والأساليب العجيبة مما سبق لي أن سمعته عن أولئك البراهمة[5] الذين يجلسون معرضين لأربع نيران يحدقون بأبصارهم إلى قرص الشمس، أو الذين علقوا منهم من أرجلهم وتدلت رؤوسهم على نيرانٍ أشعلت من تحتها، أو الذين ينظرون إلى السماء وقد لووا رؤوسهم على أكتافهم حتى استحال عليهم أن يستعيدوا وضعها الطبيعي، ومن جراء ليِّهم رقابهم هذا لم يعد شيء غير السوائل يستطيع أن يدخل معداتهم، ومنهم من يقضون حياتهم مقيدين بسلاسل وأغلال في أسفل جذوع الشجر، أو يظلون يذرعون الإمبراطوريات الواسعة بأجسامهم كما تفعل اليرقات الدودية، وقد يقف الواحد منهم بقدمٍ واحدة على عمودٍ عالٍ، فحتى هذا التكفير المقصود ليس أعسر تصديقًا ولا أغرب من المناظر التي نشاهدها هنا كل يوم.
فأفعال هرقليس[6] الاثنا عشر تعد تافهة إذا ما قيست بما يضطلع به جيراني من أعمال، فتلك اثنَيْ عشر عملًا فحسب ولها آخرها، على حين أني ما رأيت قط أن هؤلاء الناس قد قتلوا سبْعًا أو صادوا وحشًا من تلك الوحوش المريعة، أو أنجزوا أي عمل من الأعمال التي يزاولونها، فهم لا صديق لهم من أمثال أيولاس[7] يكوي أصول رأس الهايدرا [8] بحديدة محماة، ولكنهم لا يكادون يسحقون رأسًا واحدًا حتى ينبت بدلًا منه اثنان.
لقد بلغ سوء حظ الشباب من أهل بلدي أن يرثوا ضياعًا وبيوتًا وحظائر ومواشي وآلات زراعية، ذلك لأن التخلص من هذه الأشياء أعسر من اقتنائها والحصول عليها، وكان خيرًا لهم لو أنهم ولدوا في المراعي المكشوفة، ورضعوا من لبان الذئاب حتى يستطيعوا أن يروا بوضوحٍ أجلى أي حقل طلب إليهم أن يعملوا فيه. فمن ذا الذي جعلهم عبيدًا للأرض يا ترى؟ ولم يأكلوا من ستين فدانًا على حين قُضِيَ على الإنسان ألا يأكل سوى كيلة من قدر؟ لم عليهم أن يشرعوا في حفر قبورهم منذ يولدون؟ آن عليهم أن يحيوا حياة بني الإنسان، فليدفعوا بكل هذه الأشياء أمامهم وليتقدموا على خير ما يستطيعون أن يتقدموا.
فكم من رجلٍ مسكين قابلت يكاد ينوء بما عليه من أثقالٍ تكاد تسحقه وتكتم أنفاسه، فرأيته يزحف في طريق الحياة يدفع أمامه حظيرة طولها سبعون قدمًا وعرضها أربعون لم تنظف قط إسطبلاتها الأوجية[9] فضلًا عن مائة فدان من الأراضي منها ما هو للحرث والحصاد، ومنها ما هو للرعي والأخشاب. إن المحرومين من الذين لا نصيب لهم، والذين يجاهدون وليس أمامهم ما يعوقهم ويعطلهم من أمثال هذه العقبات الموروثة التي لا ضرورة لها ليدركوا أن حسبهم من العمل أن يقهروا بضع أقدام مكعبة من اللحم ثم يتعهدوها بعنايتهم واهتمامهم.
ولكن الناس يعملون وهم واهمون، إذ لا يلبث خير جزءٍ في الإنسان أن يصير إلى الأرض فيحرث معها سمادًا لها. وبحسب ما يبدو أنه مصير مقدور يسمونه ضرورة ترى الناس يشغلون أنفسهم كما ورد في أحد الكتب القديمة[10] بادخار كنوز سوف تفسدها عليهم العثة ويتلفها الصدأ وتسطو عليها اللصوص فيسرقونها. تلك حياة الحمقى من الناس كما سيتضح لهم الأمر ويتبين عندما يصلون إلى نهايتها إن لم يكن قبل. قيل إن دوكاليون وبيرها[11] خلقا الناس بأن ألقيا عليهم الأحجار من فوق رأسيهما أو كما أشار رالي[12] إلى ذلك في شعره بأسلوبه الموسيقي الرنان:
ومن ثم كان جنسنا قاسي القلب يتحمل الآلام ويعاني الهموم
ويؤيد من قال إن طبيعة أجسامنا من طبيعة الحجر.
فحسبنا هذا طاعة عمياء لكاهنة كثيرة الأخطاء. فالناس يلقون الأحجار من فوق رؤوسهم من دون أن يروا أين تقع.
إن أكثر الناس -حتى في هذه البلاد الحرة نسبيًّا- مشغولون جهلًا منهم وخطأً بهمومٍ متكلفة مصطنعة، وبأعمالٍ من أعمال الحياة خشنة غليظة لا لزوم لها، حتى أصبحوا عاجزين كل العجز عن أن يجنوا ما في الحياة من ثمار رفيعة، فقد صارت أصابعهم من جراء الإفراط في العمل شوهاء كثيرة الارتجاف، فلم تعد تستطيع أن تجني شيئًا من أمثال هذه الثمار. هذا ولم يبق لدى الرجل العامل المجد أي وقت فراغ ليكون مستقيمًا حقًّا وصدقًا استقامة وصوله.
فهو لا يستطيع أن يحافظ على خير العلاقات الجديرة بالرجولة بينه وبين الناس وإلا نزلت قيمة عمله في السوق وانحطت ولا وقت عنده ليكون شيئًا آخر غير آلة. إذ كيف يتسنى لرجلٍ يظل يستعمل معلوماته باستمرار أن يذكر ما به من جهلٍ وقصورٍ حق الذكر وهو الأمر الذي يتطلبه نموه ويستلزمه ترقيه؟ إن علينا أن نغذيَه ونكسوه بالمجان أحيانًا، كما أن علينا أن نزوده بما يقويه وينشطه قبل أن نبدي رأينا فيه ونحكم عليه أو لا. ألا ترى أننا لا نستطيع أن نحافظ على خير ما في طبائعنا من رفيع الصفات إلا إذا تناولناها برفق مثلما نتناول أزاهير الفاكهة الغضة؟ ومع ذلك فإننا لا نعالج أمورنا ولا يعامل بعضنا بعضًا بشيءٍ من هذا الترفق.
وكلنا يعلم أن البعض منكم فقراء يجدون في العيش مشقة وعنتًا حتى أنهم ليكونوا أحيانًا كالمبهورين لا يكادون يتنفسون. ولا ريب عندي في أن بعض من يقرؤون هذا الكتاب منكم لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الوجبات التي تناولوها فعلًا ولا أثمان الأكسية والأحذية الآخذة في البلى بسرعة أو التي بليت فعلًا. إنكم ما أقبلتم على قراءة هذه الصفحة إلا لكي تقضوا وقتًا ليس ملكًا لكم وإنما استعرتموه أو سرقتموه، وبذلك تكونون قد سلبتم دائنيكم ساعة من الزمان. وليس يخفى أن الكثير منكم يعيشون عيشة وضيعة خسيسة. لقد أرهفت الخبرة بصري وجعلته حديدًا! فأنتم دائمًا على طرفٍ من أمركم تحاولون أن تقوموا بالأعمال التجارية وتتخلصوا من ديونكم معًا، وتلك ورطة قديمة كان الرومان يسمونها نحاس الغير، وذلك لأن بعض نقودهم كانت تسك من النحاس. فها أنتم تعيشون وتموتون، بل تدفنون بنحاس الغير.
هذا وأنتم دائمًا تعدون أن توفوا ما عليكم من الدين، فدائمًا تعدون بدفعه غدًا، ثم إذا بكم تموتون اليوم عاجزين عن دفع ما عليكم من ديون. أراكم تحاولون التودد إلى الناس رجاء نيل الحظوة عندهم والحصول على زبائن جدد من بينهم بوسائل منوعةٍ، ولا تقفون إلا عند ارتكاب الجرائم التي قد تؤدي بكم إلى الاعتقال في سجن الحكومة. فأنتم تكذبون وتتملقون وتعطون أصواتكم لمن تريدون. تتضاءلون حتى تكونوا جماع التأدب وخلاصة اللباقة والكياسة، ثم إذا بكم تنبسطون وتتمددون حتى تصبحوا هواءً رقيقًا من الكرم الزائف. كل ذلك كي تحملوا جاركم على أن يرضى فيعهد إليكم بصنع أحذيته، أو قبعاته، أو معطفه، أو عربته، أو أن يكلفكم أن تستوردوا له ما يلزمه من صنوف البقالة، وتمرضون أنفسكم كي تستطيعوا أن تدخروا شيئًا من المال ليوم الشدة والضيق. تدخرون شيئًا تدسونه في صندوقٍ قديم، أو تخفونه في جوربٍ تضعونه خلف بلاط الجدار، أو زيادة في الحرص عليه والسلامة له تضعونه في مصرفٍ ما، فأنتم لا تبالون أنى تضعونه ولا تحفلوا بمقدار ما تدخرونه كثيرًا كان أو قليلًا.
وإني لأعجب أحيانًا أن يبلغ بنا النزق حدًّا يكاد يجعلني أقول إننا لا نعني من الاسترقاق إلا بالشكل الخشن منه، ذلك الشكل الأجنبي البعيد عنا نوعًا ما والذي نطلق عليه اسم استرقاق الزنوج.[13] فثم كثير من السادة المتحمسين الأذكياء يبلغ بهم الختل والمكر أن يسرقوا الشمال والجنوب معًا. إنه لعسير على المرء منا أن يكون عليه رقيب من الجنوب يسيطر عليه، وأسوأ من ذلك أن يكون هذا الرقيب من أهل الشمال، وأسوأ من هذا وذاك أن تكون أنت نخاس نفسك تسترقها وتستعبدها.
أتريدون أن تقولوا لي أن في الإنسان ناحية سامية قدسية؟ انظروا إلى سائق الخيل في الطريق العام وهو يمضي بعربته إلى السوق ليلًا ونهارًا، فهل ترون فيه ناحية قدسية طيبة تتحرك في نفسه؟ إن أسمى واجب عليه أن يعلف خيله ويسقيه. وما مصيره المقدر عليه إذا قيس اهتمامه بتصدير السلع في السفن إلى الخارج؟ أليس هو الذي يسوق العربة للسيد فلان؟ ألا ما أرحم هذا الرجل وأطيب قلبه وما أخلده على الزمان! انظروا إليه كيف يستخذي ويتسلل، وكيف يظل طول النهار يعاني المخاوف من حيث لا يدري. إنه ليس بالخالد ولا هو بالرحيم، بل هو عبد أفكاره وحبيس آرائه التي يراها في نفسه وهي شهرة عرف بها واكتسبها بأعماله.
إن الرأي العام طاغية ضعيف إذا ما قيس برأينا نحن في أنفسنا، فرأي الإنسان في نفسه هو الذي يحدد مصيره المقدر عليه أو بالأحرى ينم عنه ويدل عليه. فتحرير المرء نفسه إذن من سلطان الوهم والخيال له قيمته الكبرى حتى في الأقاليم الهندية الغربية. فأي ويلبرفورس[14] عندنا يهب ويضطلع بذلك التحرير وينجزه لنا؟ انظروا إلى النساء في مختلف بلاد الله وهن يعملن في إعداد لوازم زينتهن حتى آخر يوم من أيامهن؛ ترون أنهن لا يحفلن أي احتفال بما هو مقدور عليهن. كأن المرء منا يستطيع أن يقتل الوقت من غير أن يجرح الأبدية ويؤذيها!
تعيش الكثرة من الناس عيشة يأس هادئ، وليس ما يسمونه توكلاً سوى يأس مؤكد لا شك فيه. فأنت إنما تنتقل من المدينة اليائسة إلى الريف البائس وعليك أن تعزي نفسك بشجاعةٍ مثل شجاعة فأر المسك[15] والمنك.[16] إنه ليأس ثابت متحجر وإن لم يكن مشهورًا به ذلك الذي يختفي وراء حتى ما يسمونه بوسائل لعب الناس ولهوهم إذ ليس فيها أي لعب، لأن اللعب لا يكون إلا بعد الشغل، ولكن الحكمة تمتاز بأنها لا تقتضينا فعل شيء ما في يأسٍ وعنف.
أما إذا فكرنا فيما هو هدف بني الإنسان وغايتهم التي يرمون إليها، وتساءلنا عما عساها تكون الأشياء الضرورية والوسائل التي لا بد منها للحياة لتجلي لنا أن الناس قد اختاروا أن يسلكوا الطريقة المألوفة في المعيشة قصدًا وعن عمد، لأنهم يفضلونها على أية طريقة أخرى، ومع ذلك فهم يظنون أنهم مخلصون في ظنهم أنه لم يكن أمامهم طريقة غيرها فاختاروها، ولكن ذوي الطبائع اليقظة السليمة يتذكرون أن الشمس تشرق كل يوم صافية نقية، وأن وقت تخلينا عن أهوائنا وضروب تعصبنا لا يمكن أن يقال عنه إنه قد مضى وفات. هذا وإنَّا لا نستطيع أن نثق بأية طريقةٍ من طرق التفكير مهما قدم عليها الدهر وطال الزمن إلا إذا قام على صحتها الدليل والبرهان.
فما يردده كل إنسان منا اليوم ويقول به أو يمر به في صمتٍ وسكون على أنه حقٌّ وصدق قد ينقلب غدًا فيستبين لنا كذبه وزيفه، ويتضح أنه لم يكن سوى دخان لرأي اعتقد بعض الناس أنه سحابة سوف تغدق عليهم غيثًا يخصب أراضيهم. وما عليك إلا أن تجرب ما يقوله لك الشيوخ من الناس بأنك لا تستطيع أن تقوم به وتعمله تجد أن في مقدورك أن تعمله وتنجزه، فالأفعال القديمة إنما هي للشيوخ القدامى، وأما الأفعال الجديدة فللشباب. ولم يحدث أن عرف القدامى مرة المعرفة الكافية أن يأتوا بالوقود ليجعلوا النار تتحرك بما عليها، على حين وضع الناس الجدد قليلًا من الخشب الجاف تحت قدرٍ فإذا بهم يطوفون حول الكرة الأرضية بسرعة الطير وبشكل يصعق القدامى ويقضي عليهم كما نقول في تعبيرنا.
وليس الشيوخ بأفضل من ذلك، وهم لا يكادون يصلحون معلمين ومرشدين بالقدر الذي يصلح به الشبان، لأنهم لم يفيدوا من خبرتهم بقدر ما خسروه منها وأضاعوه. وإن المرء منا لتساوره الشكوك ويعتريه الريب فيما لو كان أعقل الناس وأكثرهم حكمة قد تعلم من خبرته بالحياة شيئًا ذا قيمة مطلقة، فليس لدى الشيوخ من الوجهة العلمية نصيحة ذات قيمة وشأن يقدمونها للشبان. فقد كانت خبرتهم الخاصة ناقصةً كل النقص، وكانت حياتهم خيبة ذريعة وفشلًا تعسًا لأسباب شخصية، ويجب عليهم أن يعتقدوا أنها كذلك. وربما يكون قد تبقى لهم شيء من الإيمان يكذب تلك الخبرة وبذا يكونون أصغر سنًّا مما كانوا.
لقد قضيت نحو الثلاثين عامًا على هذا الكوكب السيار، ولا زال عليَّ أن أسمع ممن هم أسن مني أول كلمة قيمة أو أول نصيحة جدية، فهم لم يقولوا لي شيئًا بعد ولعلهم يستطيعون أن يقولوا شيئًا يفيدني فيما أنا بصدده. فها هي ذي الحياة تجربة لم أجربها بعد شخصيًّا إلى حدٍّ كبير، ولكن لا يفيدني فيها أنهم هم قد جربوها من قبل، فإن كان لدي تجربة أرى لها قيمة فإنني واثقٌ كل الوثوق أن نصحائي من الشيوخ لم يذكروا لي شيئًا عنها.
قال لي فلاح ذات يوم: إنك لا تستطيع أن تعيش على الغذاء النباتي وحده، إذ ليس فيه ما يساعد على تكوين العظام، ومن ثم عني هو كل العناية بأن يخصص جزءًا من يومه ليزود جسمه بالمواد الغفل التي من شأنها تكوين العظام. قال لي الرجل ذلك وهو يسير طول الوقت يتكلم وراء ثيرانه التي تكونت عظامها من أكل النبات وحده، فجعلت تهزه بها هو ومحراثه الغليظ على طول الخط هزًّا عنيفًا على الرغم من كل عقبة تقابلها في طريقها. لا شك عندي في أن بعض الأشياء ضرورية للحياة عند بعض الناس الضعاف الذين لا حول لهم ولا قوة وعند المرضى على حين أنها عند غيرهم ليست سوى نزقٍ أو شيء كمالي، كما أنها قد تكون مجهولة كل الجهل عند آخرين غير هؤلاء وهؤلاء.
يبدو لبعض الناس أن أسلافنا قد مروا بتجارب الحياة البشرية كلها وخبروا سهلها وصعبها، نجادها ووهادها، وأنهم عنوا بكل شيءٍ وأعدوا له عدته. قال أفلين: حدد سليمان الحكيم المسافات التي يجب أن تكون بين الأشجار، وقرر قضاة الرومان عدد المرات التي يجوز للمرء أن يذهب فيها إلى أرض جاره ليجمع ما عساه يكون قد تساقط عليها من ثمار شجر البلوط من غير أن يكون قد انتهك حرماتها وتعدى عليها، كما قرروا الحصة التي يجوز أن ينالها هذا الجار من هذه الثمار.
وترك لنا أبقراط توجيهات شتى حتى عن كيفية قص أظافرنا قصًا يجعلها في مستوى أناملنا تمامًا لا أكثر ولا أقل، ولا شك في أن الملل والسأم نفسيهما اللذين يقال أنهما استنفدا ما في الحياة من تنوعٍ وسرور أمران قديمان قدم آدم، ولكن طاقة الإنسان وقدراته المختلفة لم يسبرها أحدٌ بعد ولم يعرف مداها أحد، فليس لنا أن نحكم على ما يستطيع الفرد أن يعمله على أساس أية سابقة سلفت. فما أقل ما جربنا! فأيًّا كانت دواعي فشلك إلى الآن يا بني فلا تبتئس، فمن ذا الذي يستطيع أن يعين لك الشيء الذي لم تكن أنجزته؟
يصح أن نبلو حياتنا ونختبرها بآلافٍ من الاختبارات البسيطة المنوعة، فنختبرها مثلًا بأن الشمس ذاتها التي تنضج فولي في الحقل هي التي تضيء في الوقت نفسه نظامًا من الدُّنى أشبه بنظامنا. فلو أني تذكرت ذلك لوفرت على نفسي بعض الأخطاء التي وقعت فيها من قبل، فلم يكن هذا الضوء هو نفسه الذي عزقت فيه فولي، وما النجوم إلا رؤوس زوايا مثلثات عجيبة كل العجب! فأي مخلوقات بعيدة شتى في مختلف قصور الكون تفكر في ذات الشيء وفي اللحظة عينها؛ أن الطبيعة والحياة البشرية منوعتان تنوع تكويننا، فمن منا يقدر أن يقول أي أمل تقدمه الحياة لآخر غيرنا؟ أيجوز أن تحدث معجزة أعظم من أن ينظر كلٌّ منا بعيني الآخر لحظة واحدة؟ أم ينبغي أن نعيش في جميع عصور الدنيا في ساعة واحدة؟ بل ينبغي أن نعيش في جميع دُنى العصور المختلفة في التاريخ كله؛ عصور التاريخ والشعر والميثولوجيا (الأساطير). ولست أعرف طريقةً ما للوقوف على خبرة الغير أغرب وأفيد مما يمكن أن تكونه هذه الطريقة.
إن الجزء الأكبر مما يسميه جيراني خيرًا أعتقد أنا في صميم نفسي أنه شرٌّ. وإن كنت أندم على شيء ما فمن المحتمل -كل الاحتمال- أن يكون ذلك الشيء هو حسن سلوكي. فأي شيطان استولى عليَّ حتى صرت أسلك هذا السلوك الحسن الصحيح؟ أنى لك أيها الشيخ أن تقول أحكم شيء تستطيع أن تقوله أنت الذي عشت سبعين عامًا لم تخل من شرف ما؟ ولكني أسمع صوتًا لا قبل لأحد بمقاومته يدعوني أن أبتعد عن كل هذا. فكل جيل من الأجيال يهجر مشروعات الجيل الآخر ويتركها كما تترك السفن التي تحطمت عند الشاطئ.
أظننا نستطيع آمنين أن نثق بالناس والأشياء أكبر جدًّا مما اعتدنا أن نثق، وجدير بنا أن ننزل عن شيءٍ من حقوقنا في العناية بأنفسنا بالقدر الذي نوليه نواحي أخرى بإخلاص، فالطبيعة ملائمة لضعفنا ملاءمتها لقوتنا. فالقلق المستمر والتوتر الدائم اللذان عند بعض الناس هما نوع من داءٍ عضال يكاد شفاؤه يكون عسيرًا. لقد خلقنا بشكل يجعلنا نبالغ في أهمية أي عمل نزاوله، ومع ذلك فما أعظم المقدار الذي لم ننجزه بعد! وما عسى أن يكون الأمر إذا ما أصابنا مرض؟ فما أشد يقظتنا نحن الذين عزمنا على ألا نعيش بالإيمان إذا ما استطعنا أن نتحاشاه.
فنحن حذرون، يقظون طول النهار كله ثم نؤدي صلواتنا في الليل على كره منا ونسلم أنفسنا لكثير مما نحن غير واثقين منه. نحن مضطرون كل الاضطرار وبكل إخلاص إلى أن نحيا ونُجل حياتنا ونحترمها وننكر جواز حدوث أي تغيير فيها ونقول هذه هي الطريقة الوحيدة على حين توجد طرق متعددة بقدر ما توجد أنصاف أقطار صادرة من مركز دائرة واحدة. فإن كل تغييرٍ معجزةٌ يجدر بنا أن نفكر فيها ونتدبرها، ولكنها مع ذلك معجزة تحدث كل لحظة. قال كونفوشيوس: أن نعرف أننا نعرف ما نعرفه وأن لا نعرف ما لا نعرفه ذلك هو المعرفة الحقيقية. فعندما يحول امرؤ حقيقةً من حقائق الخيال إلى حقيقة يدركها عقله فعندئذ أستطيع أن أتنبأ بأن جميع الناس سيقيمون حياتهم على ذلك الأساس في النهاية.
ولنفكر برهة فيما يكون يا ترى أغلب ذلك التعب ومعظم هذا القلق اللذين أشرت إليهما من قبل، وإلى أي مدى يكون من الضروري لنا أن نقلق أو على الأقل نحرص ونحذر. قد يكون ثمة بعض الفائدة في أن نعيش عيشة بدائية خشنة كالتي يعيشها سكان الأطراف والحدود، على الرغم من أننا نحيا وسط مظاهر الحضارة والمدنية إن لم يكن ذلك إلا لنعرف ما هي الأمور الضرورية التي لا بد منها للحياة وما الطرق التي اتخذت للحصول عليها.
أو قد يكون ثمة فائدة أيضًا في أن نتصفح دفاتر التجار القديمة لنرى ما كان الناس يشترونه عادةً من المتاجر وماذا كانوا يختزنون في بيوتهم، وبعبارة أخرى نرى ما هي أنواع البقالة الضرورية لهم. فالإصلاحات والتحسينات التي تمت في العصور الكثيرة لم تؤثر سوى تأثير طفيف في القوانين الأساسية لوجود الإنسان وحياته، كما أن هياكلنا العظمية قد لا يسهل تمييزها عن هياكل أسلافنا.
وأقصد بعبارة «ضروريات الحياة» كل ما يحصل عليه الإنسان بجهده هو وحده، وكان من البداية أو صارت بطون الاستعمال ذات أهمية خاصة للحياة البشرية حتى لم يحاول قط سوى عدد قليل من الناس -إن وجدوا- أن يستغنوا عنه، سواءً كان ذلك الاستغناء بسبب التوحش أو الفقر أو الفلسفة. فعلى هذا الأساس لا يكون عند كثيرٍ من المخلوقات سوى شيء واحد فحسب لا غنى عنه للحياة، وذلك الشيء هو الطعام.
فهو عند الجاموس البري الأمريكي (البيسون) الطليق في المراعي لا يعدو بضع بوصات مربعة من الكلأ السائغ مع قليلٍ من الماء يشربه، هذا إذا لم يلجأ إلى مأوى له في الغابات أو إلى ظل جبل من الجبال، فليس في الحقيقة حيوان ما يحتاج إلى أكثر من الطعام والمأوى. هذا وإن حاجات الإنسان الضرورية له في مناخ مثل مناخنا يمكن أن توزع على الأمور الآتية توزيعًا عادلًا صحيحًا إلى حدٍّ ما: الطعام، والمأوى، والملبس، والوقود. ذلك أننا لن نكون مستعدين للعناية بمشكلات الحياة الحقيقية ومعالجتها بحريةٍ وبأملٍ في النجاح إلا بعد أن تتوافر لنا هذه الأمور الضرورية. فالإنسان لم يخترع البيوت فحسب، بل اخترع كذلك الملابس والطعام المطهو. ولعل ضرورة جلوس الناس حول مواقد النار قد نشأت من جراء استكشافهم دفئها عرضًا وما ترتب على ذلك من استخدامهم إياها، وكان ذلك الاستخدام في البداية من قبيل الترف وأمرًا من الأمور الكمالية.
ومن المشاهد أن القطط والكلاب سريعًا ما تعتاد هذه العادة أو -إن شئت- هذه الطبيعة الثانية. فبالمأوى والملبس الصالحين نستطيع أن نحافظ شرعًا على حرارتنا الداخلية. وهل يصح لنا أن نقول إن الطهي بمعناه الدقيق قد نشأ من جراء الإسراف في هذين الأمرين أو استعمال الوقود؟ أي أنه نشأ من جعل الحرارة الخارجية أكثر من حرارتنا الباطنية؟ قال العالم الطبيعي داروين عن سكان جزائر تيرا ديل فويجو:[17] إن هؤلاء المتوحشين عاريي الأجسام الجالسين على مسافةٍ بعيدةٍ عن النار كانوا يتصببون عرقًا من جراء تعرضهم لهذا الشيء، على حين أن رفاقه كانوا أبعد من أن يكونوا متدفئين، على الرغم من أنهم كانوا يرتدون ملابس تكفيهم وجالسين على مقربةٍ من النار. فأدهش ذلك داروين[18] كل الدهشة.
وكذلك قيل لنا عن أهالي نيوهولند أنهم يسيرون عراة الأجسام من دون أن يصيبهم من وراء ذلك أي ضرر على حين كان الأوروبيون يرجفون مما كانوا يشعرون به من أثر البرد على الرغم مما عليهم من ملابس، فهل من المستحيل علينا أن نجمع بين خشونة هؤلاء المتوحشين وبين اتجاه الإنسان المتحضر إلى العناية بالأمور العقلية؟ وبحسب ما قال ليبيج:[19] يكون جسم الإنسان عبارة عن موقد وقوده الطعام الذي يستبقي الاحتراق الداخلي قائمًا في الرئتين، ولذلك صرنا نأكل في الجو البارد أكثر مما نأكل في الجو الحار.
هذا والحرارة الحيوانية تنشأ من احتراق بطيء، ويحدث المرض والموت إذا كان هذا الاحتراق سريعًا أكثر مما ينبغي، أو قد يكون سببهما عدم وجود الوقود أو وجود خلل في جهاز الهواء يجعل النار تخمد. وبالطبع يجب ألا نخلط بين الحرارة الحيوانية وبين النار على أن في هذا التمثيل ما يكفي لإيضاح المقصود. ويبدو من الثبت الذي ذكرناه من قبل أن عبارة الحياة الحيوانية ترادف إلى حدٍّ كبير عبارة الحرارة الحيوانية. فعلى حين أنه يصح لنا أن نعد الطعام الوقود الذي يستبقي النار التي فينا قائمة، وفائدة الوقود هي إعداد ذلك الطعام فحسب أو أن يزيد في دفء أجسامنا بما يضيفه إليها من حرارةٍ من الخارج. فكذلك المأوى والملبس إنما يفيدان فقط في حفظ الحرارة التي تولدت وامتصت بهذا الشكل.
فأكبر ما تحتاج إليه أجسامنا إذن هو أن تظل دافئة؛ أي أن نظل نحن محتفظين بالحرارة الحيوانية قائمة فينا. فما أكثر المتاعب التي نتجشمها في سبيل طعامنا وكسائنا ومأوانا، بل وفي سبيل فراشنا كذلك! وما فراشنا سوى ملابسنا الليلية. فمن أجلها أصبحنا نسرق أعشاش الطيور ونسلبها صدورها لنهيئ لأنفسنا هذا الفراش، هذا المأوى داخل مأوى مثلنا في ذلك مثل الخلد[20] الذي يتخذ فراشه من الكلأ وأوراق الشجر ويضعها في طرف جحره الذي يأوي إليه. لقد اعتاد الفقراء أن يشتكوا من أن هذه الدنيا باردة، وإنَّا لنعزو معظم متاعبنا وآلامنا إلى هذا البرد مباشرة، سواء كان بردًا جسمانيًّا أو بردًا اجتماعيًّا. إن الصيف في بعض الأقاليم ييسر للإنسان نوعًا من حياة الفراديس حيث لا يكون الإنسان بحاجةٍ إلى الوقود إلا ليطهو طعامه.
فالشمس ناره التي تدفئه وتنضج أشعتها الكثير من الثمار إنضاجًا. ذلك أن الطعام في جملته يكون في الصيف أكثر تنوعًا وتعددًا كما يكون الحصول عليه أيسر وأهون. أما الملبس والمأوى فلا ضرورة لهما فيه أو يكاد الأمر أن يكون كذلك. هذا وقد علمتني خبرتي الخاصة أن حسبنا في هذه البلاد وفي الوقت الحاضر قليل من الأدوات مثل السكين والفأس والمعول وعربة نقل وما إلى ذلك، ثم يلي هذه من حيث الضرورة لمحبي الاطلاع الجادين فيه مصباح وورقة للكتابة وتيسر الحصول على بضعة كتب وهي كلها أمور يسهل الحصول عليها بتكاليف زهيدة.
ومع ذلك فإن ناسًا من غير العقلاء يذهبون إلى الطرف الثاني من الكرة الأرضية -إلى الأقاليم المتوحشة غير الصحية- ليعملوا في التجارة عشر سنين أو عشرين سنة كي يعيشوا؛ أي كي يكونوا دافئين الدفء المريح، ثم ينتهي بهم المطاف أن يموتوا في نيو إنجلند. أما الأغنياء المترفون، فليسوا دافئين دفئًا مريحا فحسب، بل هم حرانون حرًّا غير طبيعي. فهم بالطبع -كما أشرت من قبل- يطهون الطهو الذي يتفق مع الموضة.
إن أغلب الكماليات والكثير مما يسمونه وسائل الراحة في الحياة ليست أمورًا غير ضرورية فحسب، بل هي عوائق إيجابية تقف في سبيل النهوض بالجنس البشري. فمن حيث الكماليات ووسائل الراحة هذه فقد عاش الحكماء من الناس دائمًا عيشة أبسط وأكثر تقشفًا من عيشة الفقراء. وكان الفلاسفة القدامى من أهل الصين وفارس والهند والإغريق طبقة لم يكن أحد أفقر منهم من حيث الثروة الظاهرية على حين لم يكن أحد أغنى منهم من حيث الثروة الباطنية.
على أننا لا نعرف الكثير عنهم، ومن عجب أن نعرف عنهم ذلك القدر الذي نعرفه، وهذا نفسه يصدق على المصلحين المحدثين والعاملين على خدمة البشر. وليس ثمة أحد يستطيع أن يلاحظ الحياة البشرية ملاحظة كلها نزاهة وحكمة وعدم تحيز إلا إذا نظر إليها من ناحية ما يجب أن نسميه بالفقر الاختياري. فحياة الترف لا تثمر إلا ترفًا سواء كان ذلك في الزراعة أو التجارة أو في الأدب أو الفن. ألا ترى أن عندنا أساتذة فلسفة الآن، ولكن لا فلسفة؟ ومع ذلك فمن البديع الرائع أن نعلم الفلسفة، لأنه من البديع الرائع كذلك أن نعيش.
فليس الفيلسوف من كان عنده أفكار وآراء تدق على الأفهام فحسب، ولا حتى من له منهم مدرسة ومريدون، ولكن الفيلسوف هو الذي يحب الحكمة حبًّا جمًّا يجعله يعيش بحسب ما تمليه عليه مبادئها وتوجيهاتها، فيحيا حياة البساطة والاستقلال وسعة العقل والإيمان والثقة بالناس، فليست الفلسفة أن تحل بعض مشكلات الحياة حلًا نظريًّا فحسب، بل أن نحلها عمليًّا ونظريًّا معًا. إن نجاح كبار الأساتذة والمفكرين أشبه ما يكون بنجاح أصحاب السلطان ورجال الحاشية.
فهو نجاحٌ لا هو بالملكي ولا هو مما يليق بالرجولة، فهم يعملون جهدهم ليعيشوا كما عاش آباؤهم تقريبًا، وليسوا هم بحال من الأحوال بالآباء الذين ينتظر منهم أن ينجبوا جنسًا من البشر أنبل مما سبقه وأشرف منه، ولكن ما الذي يدعو بني الإنسان إلى أن يتدهوروا وينحطوا هذا الانحطاط الموصول؟ وما ذلك الذي يستنفد قوى الأسرة ويقضي عليها؟ ما طبيعة ذلك الترف الذي يضعف الأمم ويهلكها؟ وهل نحن واثقون يا ترى من أن شيئًا من هذا لا يوجد في حياتنا نحن؟ إن الفيلسوف يسبق عصره دائمًا حتى في مظاهر حياته الخارجية، فهو لا يأكل، ولا يلبس، ولا يسكن، ولا يستدفئ بالشكل الذي يأكل به بنو عصره ويسكنون ويلبسون ويستدفئون. كيف يتسنى لامرئٍ أن يكون فيلسوفًا من غير أن يحافظ على حرارته الحيوانية بطرق أفضل مما يحافظ به عليها غيره من الناس؟
فلو أن إنسانًا استدفأ بالطرق المختلفة التي وصفتها فما عساه يبغي أكثر من ذلك؟ لا شك أنه لا يتطلب مزيدًا من الدفء من النوع ذاته، كأن يبغي طعامًا أكثر وأدسم وبيوتًا أوسع وأفخم وملابس أكثر وأفخر ومواقد أكثر عددًا وأشد حرارة وما إلى ذلك. فبعد أن يحصل على تلك الأشياء الضرورية للحياة لا يكون أمامه سوى بديل آخر من الحصول على ما يزيد على حاجته، وذلك بأن يغامر الآن في الحياة، فقد بدأ يتحرر من الأعمال الوضيعة ويتخلص منها.
ويبدو أن التربة ملائمة للبذور، فقد أرسلت جذيراتها إلى أسفل، ولعلها ترسل الآن فروعها إلى أعلى وهي واثقة مطمئنة. فلماذا زرع الإنسان نفسه هكذا راسخة في الأرض إن لم يكن ذلك لينهض بها صعدًا نحو السماء ذاتها؟ ذلك لأن النبات الحر تقدر قيمته من أجل ما يحمل من ثمار في النهاية في الشمس والضوء بعيدًا عن الأرض، وهي لا تعامل معاملة الفواكه الأخرى الأقل منها مرتبة والتي، وإن كانت مما يعيش سنتين، فإنها لا تترك حتى تستكمل جذورها، وكثيرًا ما يقطع من قمتها لهذا الغرض نفسه، حتى إن أكثر الناس لا يعرفونها في موسم ازدهارها.
ولست أقصد هنا أن أضع القواعد وأرسم الخطط لأصحاب الطبائع القوية الجريئة الذين يعتنون بشؤونهم الخاصة سواء منها ما كان يتعلق بالجنة أو بالنار. إنهم قد يبنون مباني أروع مما يبنيه أغنى الناس، وينفقون عن سعةٍ وإسراف أكثر منهم من دون أن يفقروا أنفسهم ومن غير أن يعرفوا كيف يعيشون، هذا إن كان يوجد حقًّا أمثال هؤلاء الناس الذين يحلم بهم. وكذلك لا أضع هذه القواعد للذين يجدون فعلًا مصادر تشجيعهم وإلهامهم في الحالة القائمة على ما هي عليه، ويطيب لهم أن يحتفظوا بها ويرعوها بتلك المحبة، وهذه الحماسة التي نعرفها عن العشاق المغرمين، وإني لأعد نفسي -إلى حدٍّ ما- من هذا الفريق.
وكذلك لا أوجه حديثي إلى أولئك الذين يشتغلون في عمل طيب -أيًّا كانت ظروفهم وأحوالهم- ويدركون إن كانوا حقًّا مستخدمين استخدامًا طيبًا أم لا، وإنما أوجه الكلام -أصلاً- إلى جمهرة الناس المتذمرين غير الراضين الذين يشكون عبثًا من قسوة الحظ عليهم، ومن صروف الزمن معهم على حين أنهم إن شاءوا لأصلحوا من أحوالهم وحسنوها كثيرًا. وثم فريق من الناس يجأرون بالشكوى من أي شيء بصورة لا يفلح فيها معهم أي عزاء يعزيهم عما هم فيه، كما يقولون إنما يؤدون ما عليهم من واجب. وفي ذهني كذلك تلك الطبقة من الناس التي يبدو أفرادها أغنياء موسرين على حين أنهم فقراء معدمون في الواقع، بل هم أفقر الطبقات جميعًا. فقد جمعوا الكثير من حطام هذه الدنيا، ولكنهم لا يدركون كيف يستخدمونه ولا كيف يتخلصون منه وبذلك صاغوا لأنفسهم قيودًا من ذهب ومن فضة.
ولو أني حاولت أن أسرد كيف كنت أود أن أقضي حياتي في السنين الماضية فلربما أدهشت قرائي الذين يعرفون فعلًا شيئًا عن تاريخ حياتي، أما أولئك القراء الذين لا يعرفون عنه شيئًا البتة، فإنهم لا شك سيدهشون حقًّا. على أني سأجتزئ هنا بالإشارة إلى بعض مغامراتي التي أعزها.
ففي كل جو من الأجواء، وفي كل ساعة من ساعات النهار أو الليل كنت أتلهف دائمًا على أن أعمل على تحسين اللحظة التي أنا فيها وأدونها في مذكراتي كذلك، وأن أقف عند ملتقى أبديتي الماضي والمستقبل[21] معًا وما ملتقاهما على وجه التحديد إلا اللحظة الحالية التي نحن فيها.
وأحب أن أقف دائمًا عند هذا الحد لا أتعداه. هذا وإني لأرجو المعذرة عما قد يكون فيما أكتب من غموض، فإن في مهنتي أسرارًا عدة أكثر مما في مهن معظم الناس، ولست مع ذلك أحتفظ بهذه الأسرار طواعية واختيارًا، ولكنها جزء من طبيعة عملي لا ينفصل عنه ولا يتجزأ. والحق أني ليسعدني أن أذكر كل شيء عنها وأن لا أضع على بابي عبارة (الدخول ممنوع).
وحدث أني فقدت منذ زمن طويل كلب صيد وحصانًا أدكن اللون ويمامة ما زلت أتتبع آثارها باحثًا عنها. فكم من سائحٍ تحدثت إليه بشأنها، ووصفت له آثارها وضروب المناداة التي تستجيب لها! وقابلت شخصًا أو اثنين ممن سمعوا نباح كلبي ورأوا وقع حوافر حصاني، بل رأوا اليمامة نفسها تختفي وراء سحابة وقد بدا عليهما أنهما يهتمان باسترجاع هذه الحيوانات كأنهما هما اللذان فقداها.
فلنبتسر الطبيعة نفسها، لا شروق الشمس وبزوغ القمر وحدهما. فكم من صباح، صيفًا وشتاءً، كنت أقوم فيه بعملي قبل أن يتحرك أي جارٍ من جيراني ويمضي لمزاولة عمله! وليس من شكٍّ في أن الكثير من أهل بلدتي قد رأوني عائدًا من هذه المغامرة، فمنهم الفلاحون المتجهون إلى مدينة بوسطن في الفجر، والحطابون الذاهبون إلى عملهم. حقًّا أني لم أساعد الشمس مساعدة مادية على شروقها، ولكن لا ريب في أنه من الأهمية بمكان أن أكون حاضرًا لأشهد ذلك الشروق.
وهكذا قضيت أيامًا كثيرة من أيام الخريف -بل ومن أيام الشتاء كذلك- خارج البلدة أحاول أن أتسمع ما في الريح. أسمعه وأنقله بكل دقةٍ، وكدت أن أودع رأس مالي كله في هذا. وزيادة على ذلك قطعت أنفاسي فيه حتى كدت أبهر وأنا أركض أمامه. ولا شك عندي أنه لو كان الأمر يعني أحد الحزبين السياسيين لنشر في الصحيفة الرسمية مع أخبار آخر ساعة. وأحيانًا أخرى كنت أرقب من مرصدي من على صخرة أو شجرة كي أبرق عن أي وافد جديد، أو أنتظر في المساء على قمم الربى إلى أن تقع السماء على خبرٍ من الأخبار، وإن كنت لم أتصيد شيئًا كثيرًا يذكر. وكان ذلك ينصهر في ضوء الشمس كما ينصهر المن ويذوب.
[1] كونكورد (Concord): بلدة في ولاية ماساتشوستس على بعد 20 ميلًا غربي بوسطن عاصمة تلك الولاية. تأسست سنة 1635 وعلى حداثتها تعد مدينة تاريخية بسبب الذكريات التاريخية والأدبية المرتبطة بها.
[2] ماساتشوستس (Massachusetts): ولاية من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي منها تطل على المحيط الأطلسي، وكانت إحدى الولايات الثلاث عشرة الأصلية التي هبت وقامت بالثورة الأمريكية التي نالت بها الولايات المتحدة استقلالها. عاصمتها بوسطن وبها العديد من البحيرات منها بحيرة والدن التي عاش فيها المؤلف سنتين بعيدًا عن العالم وعلى مقربة منه معا، وجعل اسمها عنوانًا لكتابه الذي نحن بصدده.
[3] جزائر سندويتش (Sandwich Islands): هي جزائر هاواي المشهورة الآن. استكشفها الكابتن كوك عام ۱۷۷۸ وسماها بهذا الاسم. وهي عشرون جزيرة تقع في شمال المحيط الهادئ وفيها تقع بیرل هاربر الذي اعتدى فيه اليابانيون فجأة على الأسطول الأمريكي الراسي به.
[4]نيو إنجلند (New England): إقليم في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة، عرف بهذا الاسم منذ سنة 1614 ويشمل ست ولايات هامة. كانت من أول الأقاليم التي استوطنها البريطانيون في أمريكا والذين وفدوا إليه حبًّا في الحرية الدينية والسياسية، وأثرت تقاليدهم وذكرياتهم التاريخية والأدبية في الثقافة الأمريكية.
[5] البراهمة (Brahmin): طبقة الكهنة عند الهندوس. ويعدون حراس الدين وسدنته والواسطة فيه بين الآلهة والناس، ومن ثم كانت طبقة مقدسة وتعد من الوجهة الاجتماعية أرقى الطبقات عندهم.
[6] هرقليس (Hercules): أشهر أبطال الأساطير الإغريقية القديمة ويوصف بالشجاعة والقوة الجسمانية النادرة كما يوصف في الوقت نفسه بالشفقة والرحمة.
[7] إيولاوس (Iolaus): ابن أخ غير شقيق للبطل هرقليس. وكان إيولاوس هذا صديقًا وفيًّا له يضرب المثل بوفائه، فقد عاونه من قبل على التغلب على حية الهيدرا ذات الرؤوس المتعددة بأن كوى المواضع التي يقطع عندها هرقليس رؤوسها حتى لا تنبت رؤوسٌ أخرى مكان المقطوعة.
[8] الهيدرا (Hydra): أو العدار حية خرافية يرد اسمها كثيرًا في أساطير الإغريق والرومان. حية من حيات البحر لها تسعة رؤوس، إذا قطعت رأسًا منها نبت بدله رأسان، واستطاع هرقليس أن يقتلها بمعونة صديقه أبولوس الذي صار يضرب المثل بوفائه لصديقه، ثم غمس سهامه في دمها السام حتى تكون أشد فتكًا بمن تصيبه.
[9] الإسطبلات الأوجية (Augean stables): هي إسطبلات لملك إغريقي اسمه أوجياس وهو ملك أسطوري كان يحكم إحدى مدن اليونان، له إسطبل به كثير من الغنم والماشية.
[10] هو إنجيل متى: الإصحاح السادس – الآية 19 وهي: لا تكثروا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون.
[11] دويكاليون وبيرها (Deucalion and Pyrrha): في الأساطير الإغريقية دوكاليون هو ابن بروميثيوس وبيرها هي زوجته. عندما قرر زيوس إبادة الجنس البشري بسبب تدهوره وانحطاطه قام بإرسال الفيضان لمدة تسعة أيام ولياليها ولم ينج من هلياس سوى دوكاليون وزوجته بيرها.
[12] رالي (Raleigh): السير والتر رالي مستكشف إنجليزي وسیاسي ومؤرخ وأديب وشاعر، كان أثيرًا عند الملكة إليزابيث. أعد حملة للاستكشاف في أمريكا فوصل إلى أرض في شرقها أطلق عليها اسم فرجينيا. وهو الذي أدخل البطاطس والتبغ إلى إنجلترا. وبعد وفاة الملكة إليزابيث تغير حظه فحبس في برج لندن حيث ظل اثنتي عشرة سنة في السجن كتب فيها تاريخ العالم حتى سنة ۷۳۰ ق.م. وقتل سنة ١٦١٨.
[13] كان في أمريكا وقتئذ حركة قوية ترمي إلى إلغاء الرق وكان النزاع شديدًا بشأنه بين سكان جنوب الولايات المتحدة وسكان شمالها مما أدى إلى قيام حرب أهلية بينهما انتهت بانتصار الشماليين ثم إلغاء الرق وتحرير الزنوج.
[14] وليم ويلبرفرس: 1759-1833 سياسي إنجليزي ومصلح اجتماعي تأثر من سوء حالة العبيد وما يلاقونه من تعذيب وقسوة على أيدي النخاسين وعلى أيدي أسيادهم، فجعل همه العمل على تحريرهم وإلغاء الاتجار بهم. وفي سنة 1817 وافق مجلس اللوردات على المبالغ اللازمة لتحرير العبيد في جزائر الهند الغربية.
[15] فأر المسك (Muskrat): حيوان برمائي في حجم الفأر الكبير، له ذيل مغطى بما يشبه حراشف السمك يعيش في كندا والولايات المتحدة. له غدة تفوح منها رائحة تشبه رائحة المسك ومن ثم كان اسمه. ومن عادته أن يجمع الطعام ويدخره في مكان ما ثم يطليه بالطين ليعود إليه في الشتاء. له فرو ثمين، وقد أسماه المرحوم الدكتور شرف بالرثيمة، والرثيمة هي الفأرة الكبيرة.
[16] المنك (Mink): حيوان برمائي قارض من جنس أبناء العرس بين أصابع أقدامه غشاء يعاونه على السباحة والغوص في الماء، له فرو يقدره الناس والتجار. يعيش في أمريكا الشمالية قرب الأنهار. واللفظة سويدية الأصل وتسمى بها كذلك في الإنجليزية والألمانية، ومع أن بعض الكتاب يسمونه كلب الماء أو ثعلب الماء أو قضاعة رأينا الاحتفاظ بأصل التسمية.
[17] تيرا ديل فويغو (Fuego Del Tierra): مجموعة من الجزر تقع في الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية عند مضيق ماجلان، بعضها يتبع جمهورية تشيلي والبعض الآخر يتبع جمهورية الأرجنتين.
[18] داروين؛ تشارلز داروين: 1809-1882 عالم إنجليزي من علماء الطبيعة درس الطب في إدنبرة بأسكوتلندا واللاهوت في كامبريدج. أولع بدراسة الطبيعة وعلم الحشرات في أوقات فراغه. في عام 1831 قاد رحلة على متن السفينة بيجل استمرت خمس سنوات ثم استقر في مقاطعة كينت بجنوب إنجلترا لمزيد من الأبحاث العلمية ودراسة نتائج رحلته. نشر كتابه الشهير أصل الأنواع عام 1859 والذي أثر بشكل عميق على مجموعة متنوعة من مجالات العلم وأحدث تحولًا كبيرًا في أساليب التفكير.
[19] ليبيج (Liebig): هو يوستوس البارون فون ليبيج 1803-1873. كيميائي ألماني عظيم. كان أستاذًا للكيمياء في جامعة جيسن ثم في جامعة ميونيخ ومنح رتبة البارونية سنة 1845 لما وفق إليه من كشوف علمية.
[20] الخلد (Inole): حيوان حفار يعيش في المناطق المعتدلة الشمالية في أوروبا وآسيا وأمريكا. يتغذى على الحشرات ولديه عينان صغيرتان، كل الصغر حتى ظنه الناس أنه أعمى. له أذنان مستورتان وفرو ناعم. وفي كتاب معجم الحيوان رأى الفريق معلوف أن يسمى تلبا أو طوبين وهو الاسم الذي يعرف به لدى الإسبان وذلك لأن هذا الحيوان يختلف عن الحيوان المعروف لدى العرب.
[21] يذكرنا هذا بما جاء في كتاب الشاعر الإيرلندي توماس مود عنوانه: “lalla roukh” نشره سنة 1817.