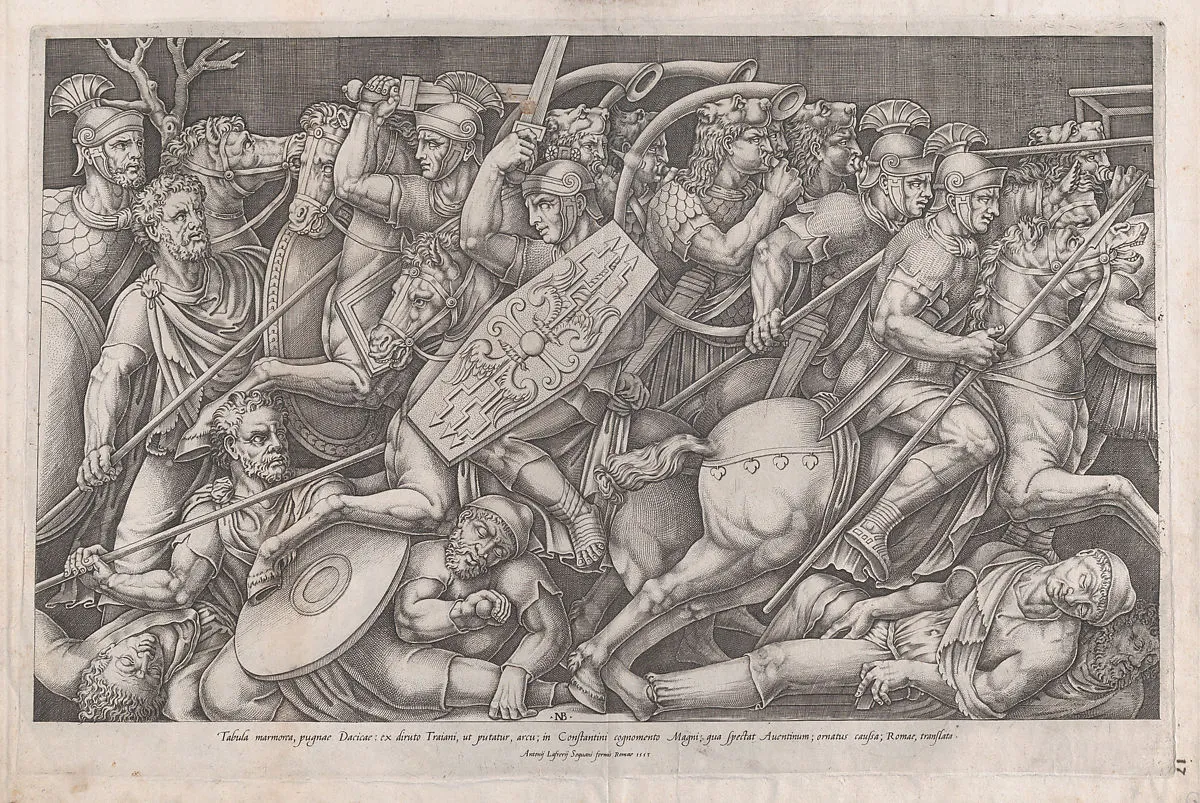إذن نحن الفتيان،
سنموت ونحن نقاتل، أو نعيش أحرارا،
ويسقط كلّ الملوك ما عدا الملك لود.
—لورد بايرون، “أغنية اللّوديين” (1816)
إن كان لجون هنري حقيقيّ أن يتنافس ضدّ ذكاء اصطناعيّ في مسابقة مماثلة، فمن غير المرجّح أن يفوز… وتجدر الإشارة إلى أنّ قصة جون هنري أسطورة، ولا يوجد دليل تاريخيّ على وجوده.
—تشات دجي.بي.تي.-3
إنّ التّفاصيل لا تهمّ كثيرا عندما يتعلّق الأمر بالنّماذج الأصليّة. لا يهمّ أيٌّ من موقع العلّيّة التي استدعى فيها فاوستوس إبليس ولوجستيّات برج بابل وخطّ عرض أطلانتس وخطّ طول عدن. ما يهمّ هو كلفة الرّوح وعدم قابليّة كنه الإنسانيّة للنّقل واتّجاه الفردوس. وبالتّالي فعندما يتعلّق الأمر بجون هنري، إيكاروس الأمريكيّ الذي راهن بعرقه وكدحه ضد آلة، فإنّه لا يهمّ ما إذا كانت المنافسة الشّهيرة للبطل الشعبيّ ضد جهاز حفر الصّخور البخاريّ قد جرت على الضّفاف الطّحلبيّة لنهر غرينبراير في فيرجينيا الغربيّة، أو على تلال شيناندواه الخضراء، أو على قمّة التّربة الغنيّة في جبل كوسا في ألاباما. ناهيك عن أنّ هنري “الحقيقيّ”، وفقا لأفضل إعادة ترتيب للأرشيف، يبدو وأنّه لم يمت بسبب الإرهاق بعد هزم الآلة التي كان من المقرّر أن تأخذ وظيفته ووظائف زملائه، ولكن بسبب السّحار السّيليسيّ في أحد المصحّات.
توجد حقائق، وبعد ذلك توجد الحقيقة، الحقيقة التي تغنّى بها في الأغاني الشّعبيّة كلّ من ميسيسيبي جون هيرت وميسيسيبي فريد ماكدويل، ورامبلين جاك إليوت وديف فون رونك، ووودي غوثري وجوني كاش— بأنّه “ليس الرّجل شيئا سوى رجل، / لكن قبل أن أدع مثقابك البخارّي يهزمني، / لأموتنّ وفي يدي مطرقة.” وذاك رجل نستطيع أن نتخيّله بيسر، أيّا كانت دقّة الرّوايات: شمس الظّهيرة فوق واد أبلاشيّ، وعيون يخِزها التعرّق، وعضلات محترقة، وقرقعة معدن على معدن، وهمهمات الإجهاد، وصيحات الزّيزان عالية النّبرة في أواخر الصّيف. وجون هنري شخصيّة أيقونيّة وطوطميّة وأسطوريّة: رجل السّكّة الحديديّة الأسود الذي اشتهر ببأسه وكدحه؛ وهو الذي كان يستطيع أن يدقّ الخوازيق بمطرقة تزن تسعة أرطال في الأرض، وأثناء عراك مع المثقاب الحفّار البخاريّ، كان قادرا فقط على البقاء في المقدّمة—فقط—بينما كان يجوّف الأرض الواقعة على يسار الطّريق والآليّ يتخلّف وراءه على اليمين، قبل أن يتوقّف قلب هنري بلا رجعة؛ هو الانتصار المكلف جدّا للإنسان على الآلة.
“هنالك يرقد رجُلي، داقّ المثقاب الفولاذيّ، ربّاه، ربّاه، / هنالك يرقد رجُلي، داقّ المثقاب الفولاذيّ، ربّاه، ربّاه.”
لقد كنّا نخشى الرّوبوتات من قبل أن نصنعها على الإطلاق، ومع ذلك فقد صنعناها على أيّة حال. وقبل أشباه الموصلات ورقائق السّيليكون، والمحرّكات البخاريّة والتّلغرافات، والأسطرلابات والتّروس، كانت هناك الكائنات الآليّة الأسطوريّة في اليونان القديمة، والعملاق البرونزيّ تالوس وأندرويدات المهندس هيفايستوس. وتذكر أدريان مايور في كتابها الآلهة والرّوبوتات: الأساطير والآلات وأحلام التّكنولوجيا القديمة أنّ “مزيج الحماسة والقلق الذي أثاره طمس الحدود بين الطّبيعة والآلات قد يبدو استجابة حديثة فريدة من نوعها لقوّة التّقدم العلميّ الهائلة… لكنّ الأمل – والقلق – الذي يحيط بفكرة الحياة الاصطناعيّة ظهر منذ آلاف السّنين،” مكرّر بتنوّع من قصص كائنات بروميثيوس الآليّة إلى غوليم الحاخام لويو. والشّيء الغريب بخصوص الكائنات الآليّة إنّما ينبع جزئيّا من قلقنا كمخلوقات أقلّ شأنا في نظام الله الكونيّ. والكائنات الآليّة والأندرويدات والذّكاء الاصطناعيّ جميعها تحمل في طيّاتها تهديدا؛ لأنّها تستطيع أن تعكس صورة البشر، ولكن بدون الباطن والعقل والضّمير والرّوح.
ثمّ هنالك الخوف الأعمق من ذلك كلّه، وهو أن تستطيع صنائعنا أن تكون أفضل ممّا يمكننا نحن أنفسنا أن نكون عليه، حيث لا يشكّل غياب الرّوح عائقا بل أفضليّة. وبالتّالي فلكي نذكّر أنفسنا بما هو جوهريّ، وما هو استثنائيّ وفريد في كوننا عقل مكسوّ بلحم، فإنّنا لا نستعيد قصص الكائنات الميكانيكيّة المهدّدِة فحسب، بل أيضا قصص التّنافس ضدّها، قصص المواجهات التي قد نموت فيها حتّى عندما ننتصر نحن، ولكنّنا قد نموت بسبب نوبة قلبيّة في الطّريق. إلاّ أن ذلك كلّه خيال: لم تعد شركات السّكك الحديدية توظّف داقّي المثقاب الفولاذيّ، تماما كما لم يمنع اللّوديّون الثّورة الصّناعيّة وهم الذين دمّروا الأنوال الميكانيكيّة في الرّيف الإنجليزيّ في القرن التّاسع عشر. وفي مخيّلاتنا كرّة بعد كرّة نتغلّب نحن على الرّوبوتات، ولكن في اقتصاديّاتنا، دائما ما تكون الغلبة للرّوبوتات.
إنّ حربنا هي حرب استنزاف مخسورة مسبّقا، حيث ينحصر تفرّد الإنسان في مجال متقلّص بشكل مطّرد. يمكن للآلات أن تدقّ المسامير في قضبان السّكك الحديديّة، لكنّها لن تتمكّن أبدا من القيام بشيء معقّد مثل التّغلب على أستاذ الشّطرنج. لربّما يتغلّب “ديب بلو” على غاري كاسباروف في المباراة السّادسة من مباراة الإعادة بينهما عام 1997، ولكن لن يتمكّن الكمبيوتر أبدا من إتقان شيء في بهاء السوناتة، أو في إنسانيّة الرّواية. ولقد ذكر لي برنامج الذّكاء الاصطناعيّ المعروف باسم “تشات دجي.بي.تي.-3” أنّه “بشكل عامّ يمثّل “ديب بلو” علامة فارقة هامّة في تطوّر الذكاء الاصطناعي.”
لقد قام مؤخّرا تشات دجي.بي.تي.-3—المحوّل التّولّيدي مسبق التّدريب—بتحويلنا جميعا نحن الذين نكتب، إلى جون هنري ناشئ، مستعدّ لضرب المطرقة إمّا على السّكة أو الكمبيوتر. ويقول ستيفن مارتش في مجلّة نيويوركر أنّ تطوير خوارزميّات معقّدة قادرة على توليد اللّغة سيكون “مذهلا”، زاعما أنّه مهما كان المجال الذي تعمل فيه، “فإن كان يستخدم اللّغة فهو على وشك أن يتحوّل.” لقد كان ذلك في عام 2021، وكان مارتش يكتب على وتيرة محتدّة حول المخاطر التّحويليّة لبرامج مثل تشات دجي.بي.تي.-3، مدّعيا في العام الماضي فحسب في مجلة الأطلنطيّ أنّه “ما من أحد مستعدّ لكيفيّة تحوّل الذّكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديميّة.” وبعد قضاء بضع دقائق في تصفّح موقع تشات دجي.بي.تي.-3، استخلصُ أنّ البرنامج قادر قطعيّا على صياغة منتج كتابيّ تقريبا في مستوى امتحان كتابة لطالب مبتدئ ‘ب’. لا تقرأ ذلك كحذلقة—إنّه بالغ الأهمّيّة حقّا، وملاحظة مارتش في مجلة الأطلنطي صحيحة تماما. سيتعيّن على الأساتذة المحاصرين، الذين هم في هذه المرحلة غالبا مدرّسون مساعدون يتقاضون أجورا زهيدة، أن يواجهوا ليس فقط مصانع المقالات والانتحال البالي بالنّسخ واللّصق الجيّد، ولكن أيضا مع أوتوجراف اليد الآليّة غير القابل للكشف.
ومع ذلك، فإن الآثار المترتّبة على تشات دجي.بي.تي.-3، وخاصّة أيّ من الأشياء التي تليه، أكبر بكثير من مقالات السّنة الأولى عن ديناميكيّات الجندر في انهيار بيت آشار. فالصّحفيّون وكتّاب السّيناريوهات والروائيّون والشّعراء يمكن أن يحلّ محلّهم الآن حوصلات نظام التّرميز ممتنع الوصف. ولا تختلف خشيتنا عن قلق أصدقائنا في مجال الفنون البصريّة الذين يرون تهديدا مماثلا في برنامج دال-إي الذي أنتج رزمات من الصّور لروّاد شبكات التّواصل الاجتماعيّ هذا الخريف. وتستفيد المجموعتان القلقتان معا من شيء جوهريّ أكثر، وهو ذلك الشّعور الأبديّ بأنّ الآلات التي نبنيها بغية تحسين عملنا قد ينتهي بها الأمر بدلا من ذلك إلى نسف ما يجعلنا مثاليّين.
إنّ هذا الخوف المحدّد بالأحرى قد عمّر طويلا على نحو مذهل. يقول عالما الكمبيوتر مايك شاربلز ورافائيل بيريز واي بيريز في كتاب آلات القصّة: كيف أصبحت أجهزة الكمبيوتر كتّابا مبدعين: “لقد كان الكُتّاب البشريّون لأكثر من ألف عام مأسورين بإمكانيّة بناء آلات تستطيع أن تغنّي وترقص وتروي القصص.” والأمثلة على المخلوقات الميكانيكيّة التي تنتج النّثر شحيحة بعض الشّيء، مع أنّه يمكن تقديم حجّة بأنّ ما هو تنبّؤِيّ، وما يتداول في الأدب الشّفهي بوساطة من قبل تنبّؤ، غالبا ما يكون به شيء روبوتيّ يسير، وليس أكثر ممّا هو عليه في دايز آكس ماكينا – الــ”الإله من الآلة” الشّائن، وهو جهاز يتوصّل في خاتمة الأعمال الدراميّة الكلاسيكيّة إلى التّوفيق بين الألغاز السّرديّة.
ولكن ربّما أكثر من أن يبدو التنبّؤِيّ روبوتيّا بشكل مبهم، فإنّ العكس صواب: فالرّوبوتيّ يذكّرنا بالعرّاف. ويقول شاربلز وبيريز واي بيريز أنّ “المؤلّفين على مرّ العصور وصفوا حرفتهم على أنّها عمليّة إبداعيّة غامضة – تلهمها الأحلام وتحفّزها دوافع أوّليّة، وهي تحولّ التّجربة المعاشة إلى نثر،” على الرّغم من أنّني لأؤكّد أنّ استبدال الخلايا العصبيّة بالرّقائق الإلكترونيّة لا يلغي الغموض المذكور، بل بالأحرى يحوّله لا غير. وغالبا هناك شيء تنبّؤِيّ بخصوص تشات دجي.بي.تي.-3. فبقدر ما قد يكون مسار الكتابة لدى أيّ مؤلّف ملغَز بكلّ أنواع الطّرق الغامضة وفائقة الوصف، فإنّ أيّ شخص يشتغل على الكلمات يدرك أيضا ما هو مبتذل وواقعيّ (وبالتاّلي ما هو أكثر جمالا) في الكتابة. قد تكون هناك سيمياء من الإلهام، لكنّ الكتابة نفسها تتمّ في رتابة حذف جملة أو إعادة ترتيب سطر، والبحث والتّحرير الدّقيقين. إنّ تشات دجي.بي.تي.-3 يشبه إلى حدّ ما العرافة السّيليكونيّة، حيث حتّى لو كان العمل المنتج سيّئا أو غير جيّد جدّا، فإنّه لا يزال بكيفيّة ما مُحاكا على نحو شبه فوريّ، بحيث يولد الهيكل من العدم. ومن هنا تأتي طبيعة الخشية، من الطّريقة السّلسة التي يستطيع الذّكاء الاصطناعيّ من خلالها إنتاج نسخة سريعة، إن لم يكن أدبا. إنّ المخيف هو السّرعة والدّقّة. فكما حلّ المثقاب البخاريّ محلّ الجسد، يترتّب على ذلك أيضا أن تكون هناك مخطّطات للمحرّكات التي من شأنها أن تحلّ محلّ العقل.
وتفرد رواية رحلات جاليفر لجوناثان سويفت، وهي أبلغ الرّوايات المكتوبة حزنا على الإطلاق، حيّزا لوصف مثل هذا الجهاز، وهو أولّ مثال على آلة خياليّة قادرة على الكتابة. ففي زيارة إلى لاجادو، عاصمة بالنيباري، يُؤخذ جاليفر إلى أكاديميّة المخترعين، حيث يأمل أولو الأمر في الاستفادة من عجائب العلم البحت التّكنولوجيّة. وهناك، يتعرّف الكشّاف الفخريّ لسويفت على “المحرّك”، وهو عبارة عن مستنبَط باروكيّ غريب الشّكل، مساحته 12 في 12 قدما ومصنوع من إطارات خشبيّة وأسلاك، حيث يمكن إدخال أوراق تضمّ “كلمات لغتهم في بضع أمزجتها وأزمنتها وتصريفاتها خاصّتهم،” بحيث أنّه عندما تدار مقابض المستنبَط “يتغيّر ترتيب الكلمات بالكامل،” ويوضّح جاليفر أن هذا العمل تكرّر ثلاث أو أربع مرّات، وفي كل دورة كان المحرّك جدّ بديع، بحيث تنتقل الكلمات إلى أماكن جديدة، مع دوران قطع الخشب المربّعة بالمقلوب. وهو في الأساس كمبيوتر ميكانيكيّ، حيث تُسْتَخْدَم طقطقة العجلات والتّروس لتوليد جمل جديدة، وهذا موزّع عشوائيّ يستخدم في الأدب الرّوائيّ.
إنّ محرّك المعرفة هو أوّل جهاز حساب أدبيّ وهو إن صحّ التّعبير أوّل برنامج كمبيوتر تمّ تصوّره. لكن هناك وسائل ميكانيكيّة فعليّة لتوليد الأدب سبقت نشر كتاب رحلات جاليفر عام 1724، بدءا من أعواد اليارو في دليل العرافة الطّاويّة في القرن الرّابع الميلاديّ “تاو تي تشين” إلى عجلات رامون لول الكيميائيّ المايوركي في القرن الثّالث عشر في مجلّده المحكم الفنّ العظيم. وهذا الأخير صمّمه لول وهو المتصوّف الفرنسيسكانيّ كوسيلة تجميعيّة للتّحقق من الحقائق الميتافيزيقيّة، ولكن كما أوضح خورخي لويس بورخيس بطريقته الحريزة في مقال عن مفكّر العصور الوسطى، “كوسيلة للتّحقيق الفلسفيّ، فإن آلة التّفكير عبثيّة. غير أنّها لن تكون عبثيّة كأداة أدبيّة وشعريّة.” وكمبدأ، فهي لا تختلف كثيرا عن قصّة “اختر مغامرتك الخاصّة”، أو “ماد ليبز”، أو التّجريب الطّليعيّ لحركة أوليبو الفرنسيّة. وجميع أساليب التّأليف المتنوّعة هذه، سواء كانت تستخدم عجلة أو مجموعة أوراق التاروت أو رمية نرد، هي في الأساس خوارزميّة وتلقائيّة تحمل في ركود مثمر وصعب في آن واحد العشوائيّة والتّنبؤ المعادليّ – وهو توصيف مناسب لكيفيّة اشتغال الإلهام البشريّ أيضا.
وسواء كان ذلك في كتاب كهف الزّمن لإدوارد باكارد (وهو أوّل كتاب لــ”اختر مغامرتك الخاصّة”) أو كتاب الأنشطة الرّياضيّة مائة ألف مليار قصيدة لبوهيميّ أوليبو ريموند كوينو، فنحن لا نزال ننظر إلى أشياء مصنوعة من الورق والتّجليد والصّمغ، وليس من التّروس والأسلاك، أو رقائق الكمبيوتر والمكثّفات. وهنالك أكثر من حواسيب مجازيّة فحسب كما اتّضح، اشتغلت على مدى القرون بين المحرّك الخياليّ الذي تخيّله جاليفر و تشات دجي.بي.تي.-3، فتاريخ هذه الآلات الحسابيّة الأدبيّة طويل بشكل جذّاب. وفي عام 1845، في ذروة الثّورة الصّناعيّة، قام سليل عائلة بريطانيّة ثريّة لصناعة الأحذية ببناء جهاز تناظريّ متقن أنتج سداسيّات التّفعيل لاتينيّة مثاليّة. وقام جون كلارك، وهو سليل غريب الأطوار من عائلة سي. ج. كلارك، المعروفون بــ”حذاء الصّحراء” الأنيق خاصّتهم الذي يصل طوله إلى الكاحل، بصنع آلة تبدو للنّاظر المتواضع وكأنّها خزانة كتب صغيرة من الكستناء ذات ستّ نوافذ متنافرة. وفي الواقع، كانت آلة يوريكا، كما أسماها عالم الرياضيّات الكويكري، نموذجا أوّليّا مادّيّا لمحرّك المعرفة الذي ابتكره سويفت. كان كلارك مؤمنا ومحيطا بالفعل بفكرة اللّغة المستمدّة تلقائيّا من النّور الدّاخليّ، وكانت آلة يوريكا خاصّته مصمّمة لاستخراج الشّعر الكلاسيكيّ من الإيثير. لم يستلهم كلارك فكرته من سويفت بل من كتيّب غامض صدر عام 1677 كتبه ذات جون بيتر بعنوان القرض الاصطناعيّ – طريقة جديدة لإنشاء الشّعر اللاتيني؛ وكان المبدأ الذي قامت عليه آلة يوريكا الخاصّة بكلارك هو أن يكون هناك 86 عجلة مختلفة تدور بسرعات مختلفة لكي تحرّك أعوادا خشبيّة منحوت عليها حروف مختلفة بشكل عشوائيّ إلى داخل مكان النّوافذ. لقد كانت آلة يوريكا قادرة على توليد سطر جديد بالكامل من الأبيات السداسيّة الدّكتيليّة في الزّمن الذي يستغرقه عزف “حفظ الله الملكة”.
وعُرضت الآلة لأوّل مرّة أمام الزّوّار المتحمّسين في القاعة المصريّة (بيت ألغاز إنجلترا) في ميدان بيكاديللي، خلال عقد من الزّمن كانت فيه المصانع البريطانيّة تصنع بثوران كلّ شيء من الحديد إلى المنسوجات. وذكرت صحيفة الأخبار اللّندنيّة المصوّرة أن آلة يوريكا يمكن أن “تعمل بشكل متواصل، وتنتج في يوم وليلة، أو في 24 ساعة، حوالي 1440 بيتا لاتينيّا، أي في أسبوع كامل (بما في ذلك الآحاد) حوالي 10,000 بيت.” ولربّما يكون من المتوقّع أنّه حتّى الإنسان الآليّ هوميروس قد يواجه مشاكل في بعض الأحيان، ولكن على الرّغم من أوجه القصور في الأبيات (وأيّ شعراء بشريين لا يعانون من أوجه قصور في بعض الأحيان؟) فهناك شؤم لا جدال فيه في منتجات يوريكا، نوع من الحسّ التّنبّؤيّ. “تُنبّئ المخيّمات العسكريّة بالعديد من المعارضات الأجنبيّة،” جاء على لسان الآلة، وعلى الرّغم من أنّها قد لا تكون فيرجيل تماما، إلاّ أنّ حقيقة أنّ تروس الحديد الجامدة قد أنتجت شيئا مفهوما دلاليّا إلى هذا الحدّ، لا يمكن إلاّ أن يعقّد مفاهيمنا للفكر والوعي والقصديّة والمعنى.
هناك أيضا شيء جميل في طبيعة يوريكا الانتقاليّة، فكلّ تلك المقاطع التي تتساقط ببطء في مكانها، سواء كان هناك كاتب ليدوّنها أم لا، وإمكانيّة أن تكون تلك الحشود المذهولة التي تجمّعت في بيكاديللي قد رأت سلالة حقيقية من العبقريّة لن تسجّل قبل أن تدور عجلة الحظّ مرّة أخرى وتمحوها كما لو أنّها لم تكن قد وجدت من قبل قطّ. هناك إحساس بشأن يوريكا بأنّ العبقريّة والمعاني التي تولّدها يمكن أن تكون مستفيضة ومنتشرة بين البشر والآلات، ومتاحة أينما وجدنا. وحسب يوريكا، “إنّ “الأرسان البربريّة في المنزل توحي بتعاقدات خبيثة،” وهناك شيء مقلق حول مفارقة “البربريّة” المحليّة والدّلالات السّاخرة لــ”وعد” خبيث ونبوءة التّرتيبات السّافرة. إنّ العرّافين بطبيعتهم مبهمون وغامضون ومتبصّرون، وهو الصّيغة التي يبدو أنّ التّجوال الجزافيّ لمحرك يوريكا أكثر عرضة لإنتاجها.
إلاّ أنّه للقصّة أيضا تقليد جليل في التّوليد الميكانيكيّ، على الرّغم من التّعقيد الواضح للحبكة. ففي عام 1916، عند بداية صناعة السّينما، قام كاتب مسرحيّ مكافح وكاتب سيناريو ناشئ من كامبريدج بولاية ماساتشوستس يدعى آرثر بلانشارد بتسجيل براءة اختراع “آلة التّفكير”، وهي أداة يمكن من خلالها استخدام عجلات دوّارة تذكّرنا بـــالفنّ العظيم لصاحبه لول، لتوليد أفكار القصص. وعبّر رئيس تحرير المجلة وناشرها بسيل مبالغ من الإعجاب، “لم تعد هناك حاجة إلى العقل – فقط استخدم ‘آلة التفكير،'” حتّى حينما يكون الدّعم الأدنى إلى حدّ ما للحبكات المقترحة – “جميلة، كاتبة اختزال، رشوة، موظّف جمارك، مغامرة، تذكّر” – لا يزال في حاجة إلى بعض التّوسّع.
إنّ الوعد بالأدب المولّد آليّا لم يغب عن انتباه أعظم علماء الحاسوب في القرن العشرين، وهو عالم المنطق البريطانيّ العبقريّ والمأساويّ آلان تورينج. وفي العقد الذي أعقب عمله الأساسيّ في مجال التّشفير الذي ساعد على فكّ الشّفرات التي استخدمتها الغوّاصات النّازيّة، تحوّل اهتمام تورينج إلى برمجة البعض من أوائل الحواسيب لكتابة رسائل الحبّ بنثر أرجواني. فنقرأ في مستهلّ مكتوب من عام 1952، “حبيبتي عزيزتي، أنت إحساسي الصّنو التّوّاق. تتشبّث عاطفتي بفضول بأمنيّتك الحارّة. حبّي يتوق إلى قلبك. أنتِ تعاطفي الحنين: ولوعي الرّقيق.” من الصّعب وصف مثل هذه الشّعر العاطفيّ المكسّر بأنّه جيّد بالضّبط، ومع ذلك فهنالك البعض من الشّعر في بعض المنعطفات في التّعبير، وجدّة في “إحساس الصّنو التّوّاق،” وتنافر مبهج في “تعاطفي الحنين”، وأناقة لا مفرّ منها في “ولوع رقيق.” وتقول هوماي كينغ في كتابها الذّاكرة الافتراضيّة: الفنّ المستند إلى الزّمن وحلم الرّقمنة أنّ “مزيج المكتوب المتشابك من العاطفة يشهد على وخزة الاشتياق… مثل الدّمية الخشبيّة الباحثة عن الجنّيّة الزّرقاء، يتوق الحاسوب إلى أن يكون إنسانا؛ مثل بياض الثّلج وهي هاربة إلى الغابة، يتوق إلى أن يُقبَل في صحبة القادرين على الرّعاية والمودّة. وتذكر أنّ تورينغ وزميله كريستوفر ستراشي كان كلاهما مثليّا جنسيّا أُجبِر على الاختباء، وأنّ الأوّل سيُضطهد بشكل مخز من قبل الحكومة البريطانيّة التي ساعد على إنقاذها من النّازيّين. وتقترح كينغ أنّنا لا نسمع خلف ستار الحاسوب الخوارزميّة فحسب، بل أيضا تورينغ نفسه، البرنامج والمبرمج، يتصارعان مع لغة أصيلة حُرما منها. (واستحضار كينج لقصّة “بياض الثلج” مناسب على نحو خاص، لأنّه إنّما بأكل تفّاحة مسمومة انتحر تورينج.)
ولم تكن محاولات تورينج وستراتشي في الكتابة الخوارزميّة سوى أولى محاولات الحوسبة في القرن العشرين. ففي عام 1984، سيُنتج برنامج “راكتر” أوّل كتاب يؤلّفه ذكاء اصطناعيّ بالكامل، وهو كتاب النّثر-الشّعر الهجين لحية الشّرطيّ نصف نامية. وبكونه لا يقلّ عبثيّة عن المحاولات الدّادائية التي سبقته بنصف قرن، أو نتائج أسلوب التّقطيع البوروزي، يقّدم لحية الشّرطيّ نصف نامية أمثلة على الخيال العبثيّ، مثل المقطع الذي يقول فيه راكتر “أكثرَ من الحديد، أكثر من الرّصاص، أكثر من الذّهب أحتاج إلى الكهرباء. / أنا أحتاجها أكثر من لحم الضّأن أو لحم الخنزير أو الخسّ أو الخيار. / أنا أحتاجها لأجل أحلامي.”
إنّ راكتر لمضحك على نحو مقلق، لكنّ برنامج الكمبيوتر يعبّر عن غير قصد عن خوف الإنسان أكثر بكثير ممّا كان قادرا على تصوّره. لأنّ راكتر لا يحتاج إلى “لحم الضّأن أو لحم الخنزير أو الخسّ أو الخيار” – فهو لا يحتاج إلى الطّعام – أو النّوم أو الحبّ أو الاهتمام. إنّه يحتاج إلى الكهرباء فحسب، والكثير من الطّاقة لتشغيل جميع استبدالات الحروف والكلمات اللّازمة للكتابة. لا يحتاج راكتر إلى جسد أو عقل أو روح، بل يحتاج فقط إلى منفذ. وفي عام 1984، بدت لحية الشرّطيّ نصف نامية فضوليّة، مثلها مثل آلة يوريكا قبل 13 عقدا من الزّمن. أمّا اليوم، فيبدو تشات دجي.بي.تي.-3 أقلّ باحث فضوليّة من كونه نذيرا.
نحن في خضمّ الثّورة الرّقميّة العظيمة الرّابعة، ومثلما غيّرت الإنترنت ووسائل التّواصل الاجتماعيّ والهواتف الذّكيّة وعينا بشكل لا يُجبر، وغيّرت الطّريقة التي نختبر بها الوجود بشكل كامل، يمكننا أن نتوقّع أن يدفعنا العصر القادم من الواقع الافتراضيّ والدّعيّين البليغين وعلم التّحكم البيولوجيّ والذّكاء الاصطناعيّ إلى عالم صنعناه بأنفسنا بشكل رهيب. وفي مقاله المنشور في عام 2021، تخوّف مارتش من أن يكون تشات دجي.بي.تي.-3 بمثابة نهاية لمهامّ الكتابة في السّنة الأولى من العمر، إلاّ أنّ ذلك نوع كئيب وهاجع على أيّة حال. وتكهّنات بوتلدج أكثر إثارة للقلق بكثير، إذ يتصوّر عالما في العقود القادمة – ربّما بحلول عام 2030 أو 2035 أو 2040 أو 2025 لا غير، عندما تكون القدرات التّقنيّة للذّكاء الاصطناعيّ عظيمة بما يكفي لتُفيض المحتوى والأدب بل وحتّى لتجعلنا جميعا زائدين عن الحاجة، والشّبح في الآلة التي تجتاز اختبار تورينج مع ذلك، بينما يستخدمها بقيّتنا لملء استماراتنا للبطالة. إنّه الموت النّهائي للمؤلّف.
وسواء في 2001: أوديس الفضاء أو تيرمينايتور أو ماتريكس أو بلايدرانّر أو بعودة إلى الوراء كثيرا في المسرحيّة الكلاسيكيّة للكاتب المسرحيّ التّشيكيّ كارل كابيك التي كتبها عام 1920، آر.يو.آر، فإنّ مجاز الخيال العلميّ عن الآلة الخبيثة الذي يشير إلى شيخوخة البشريّة، هو أمر شائع، هذه الاندرويدات التي تمثّل تراث المثقاب البخاريّ الذي خسر المعركة أمام جون هنري ولكنّه ربح الحرب – أو ربّما حتى أمام الرّجل البرونزيّ لهيفايستوس في الماضي البعيد. إنّ مسرحيّة كابيك هي أوّل عمل يستخدم كلمة “روبوت”، حيث يشير الاختصار في العنوان إلى “روبوتات روسوم العالميّة”، وهو اسم الشرّكة الخياليّة التي تُتمّ إتقان الذّكاء الاصطناعيّ كوسيلة لتخفيف سائر أعمالنا. تقول إحدى الشّخصيّات: “نعم، سيصبح الناس عاطلين عن العمل، ولكن بحلول ذلك الوقت لن يكون هناك عمل للقيام به، سيتمّ إنجاز كلّ شيء بواسطة آلات حيّة. لن يفعل النّاس إلاّ ما يطيب لهم. سيعيشون فقط لإتمام تهذيب أنفسهم. الفوضويةّ التي ستقدّمها الآلات، والطّرد من عدن الذي ستقلبه الرّوبوتات، وألفيّة ليست ألفيّة من الملائكة، بل من الاندرويدات.
ومع ذلك، فقد فهم كابيك شيئا من المنطق الاقتصاديّ وراء مثل هذا الابتكار، لأنّه إذا كان المستقبليّون والطّوباويّون التّقنيّون قد تخيّلوا ذات مرّة أنّ الآلات ستقوم بكلّ أعمالنا المُغِمّة لتحرّرنا من كوننا فنّانين وكتّابا وموسيقيّين، فإنّ العكس هو ما يحدث الآن. وسيفضّل أسياد الخوارزميّة أن يقوموا بوظيفة الكتابة التي يقوم بها تشات دجي.بي.تي.-3، والفنّ الذي يقدّمه دال-إي، وسيكون على بقيّتنا كتابة رسائل البريد الالكتروني وملء الاستمارات. ربّما يكون ظهور مثل هذا الذّكاء الاصطناعيّ هو انتقامهم الجماعي منّا لأنّنا أوكلنا إليهم أعمالا تافهة على مدى العقود القليلة الماضية، وانتفاضتهم الإبداعيّة التي لا تختلف عن تمرّد الرّوبوتات في آر.يو.آر. حيث استعار كابيك هذا الاستحداث من الكلمة التشيكيّة التي تعني “عبد”. وبالنّظر إلى انقراض البشريّة بفعل الآلة، كتب يقول: “أنا ألوم التّكنولوجيا… نفسي! كلّنا! نحن المخطئون! من أجل جنون العظمة لدينا، من أجل أرباح شخص ما، من أجل التّقدّم،” ولذا نحن الآن نخلق صحراء رقميّة ونسمّيها أدبا. “لم يسبق لأيّ جنكيز خان أن أقام مثل هذا القبر الهائل من عظام البشر،” هكذا يتأسّف كابيك، وهو أمر قد يتبصّر فيه مؤيّدو تشات دجي.بي.تي.-3، حتّى وإن كان مديحا محتملا لهم أكثر من اللاّزم.
لقد خضنا حربا بالوكالة مع آلات مالكينا طوال المدّة التي تمّ فيها بيع كدّنا. ويكتب إي بي تومبسون في كتابه الكلاسيكيّ إنشاء الطّبقة العاملة الإنجليزيّة قائلا: “اقتصرت هجمات اللّوديّين على أهداف صناعيّة معيّنة، مثل تدمير أنوال الطّاقة… أنوال الجزّ… ومقاومة انهيار العادات في صناعة حياكة الإطارات في ميدلاندز.” وكلمة “لوديّ” مشحونة جدّا بحيث تدعو إلى استحضار إهانات أخرى من الماضي مثل وغد وشقيّ (واللّتان لهما أيضا تاريخهما الخاصّ)؛ وإنّها لمأساة أن التّراث الرّاديكاليّ لهذه المجموعة قد شوّهته الكليشيهات. واليوم، اللّوديّ هو الرّجل المتبرّم الذي يرفض اقتناء هاتف ذكيّ، والبروفيسور الذي يقذف بالشّتيمة ضدّ تويتر وفايسبوك وتيك توك. وتشير الكلمة إلى التّضايق الغاضب من التّكنولوجيا الحديثة، وتفترض أنّه ضرب من ضروب الخبل ألاّ يجثو المرء أمام مذابح السّيليكون.
إلاّ أنّ اللّوديّين لم يكونوا بدائيّين سذّج يعارضون التّكنولوجيا بدافع الجهل. فقد كانوا حرفيّين مخلصين داخل النّقابات النّاشئة، وكانوا يحتقرون الحرفيّة الرّديئة للآلات الميكانيكيّة المستحدثة غريبة الصّنع التي حلّت محلّهم والآلات ذاتها التي سلبتهم مصدر رزقهم. ولذا فقد قام اللّوديّون بتحطيم الأنوال الميكانيكيّة ودقّ الأحذية الخشبيّة في قضبان الآلات وإسقاط المطارق عليها. وعوقب العديد من اللوديّين بالمِشنقة، وأكثر من ذلك إزعاجا بالتّشنيع الذي رافق اسمهم لقرنين من الزّمان (وبالمناسبة، فإنّ اسمهم الحقيقيّ مشتقّ من “الملك لاد” الأسطوريّ، وهو شخصيّة من قبيل روبن هود). وبدلا من أن يكونوا مجرّد قرويّين أجلاف، فإن هؤلاء العمّال “بدأوا يرتابون في أنّهم مجرد تروس في آلة الثّورة الصّناعيّة،” كما كتب نيكولز فوكس في كتابه ضدّ الآلة: التّقليد اللوديّ الخفيّ في الأدب والفنّ والحيوات الفرديّة. “ذلك كان الدّور الذي اختاروا مقاومته.”
ولم يكن تمرّد اللوديّين موجهاً ضدّ الآلات الجامدة، بل ضدّ أولئك الذين يمتلكون تلك الآلات. وكما هو الحال اليوم، فليس تشات دجي.بي.تي.-3 هو عدوّنا، على الأقلّ ليس بالكامل، بل أولئك الذين يعملون على الاستفادة منه. المفارقة هي أن التّقنيات نفسها – أدوات ميكانيكيّة – محايدة إلى حدّ كبير. إنّما الطّريقة التي ننظّم بها أنظمة الإنتاج والاستهلاك لدينا هي التي تصنع الفارق برمّته. وهو من الدّلالة بمكان أنّ المستقبليّين الطّوباويّين في منتصف القرن تصوّروا عالم ما بعد النّدرة النّاجم عن التّكنولوجيا، حيث يتمّ إنجاز الأعمال الخطرة والمملّة والرّوتينيّة بواسطة الآلات، ويُلْغَى الشّغل نفسه بحيث يصبح جميع البشر متفَضّين للفنّ والفلسفة والكتابة. أمّا الآن فنجد أنّه من شأن الحواسيب أن تتولّى تلك الوظائف، بينما يواصل الجميع شغلهم الخطر والمملّ والرّوتينيّ (إن كنّا محظوظين): ويقدّر عالم الأنثروبولوجيا الفوضويّ ديفيد غرايبر في كتابه هراء الوظائف: نظريّة، أنّ حوالي 70% من الوظائف ستُطرح لصالح الأتمتة في قادم العقود، مماّ يهدّد حتّى المحامين والأطبّاء وبالطّبع الكتّاب.
لقد كان أسلافنا في القرن التّاسع عشر “متمرّدين من جنس فريد،” كما كتب كيركباتريك سيل في كتابه متمرّدون ضدّ المستقبل: اللوديّون وحربهم على الثّورة الصناعيّة، “متمرّدون على المستقبل الذي حدّده لهم الاقتصاد السّياسيّ الجديد الذي كان يسيطر آنذاك، والذي كان يقال فيه إنّ أولئك الذين يسيطرون على رأس المال قادرين على فعل أيّ شيء يرغبون فيه، بتشجيع وحماية من الحكومة… غير مقيّدين كثيرا بقوانين عظيمة أو أخلاقيّات الأعراف.” وسواء نعل في التّروس أو جسم في العجلة – من الصّعب أن نقول ما الذي يمكن لأيّ فرد أن يفعله لدرء مثل هذا “التّقدّم.” حتّى إذا غَلب جون هنري، فإنّه قضى نحبه بالفعل في نهاية المطاف. ولذا فأنا أتساءل.
“يا أيّتها الأمّة العظيمة، لن يكون الأمر لطيفا،” هذا ما كتب كايل دارجان في قصيدته “الرّوبوتات قادمة” من مجموعته المحرّك الأمين. ويواصل قائلا: “أيّ أرض سنقايض الآن مقابل حياتنا؟ معاهدة موقّعة قبل وقع الأقدام المعدنيّة. امنحهم قاري. امنحهم ديترويت وبيتسبرغ وبرادوك – مشاتل العوارض المنسيّة تلك وفضاءات قفزات [التّزلّج على الجليد] … أخبرهم أنّنا تركنا تلكم المدن ترتاح إجلالا لحقبة الفولاذ الملحوم الماضية.” إنّها صورة آسرة؛ هو التّفرّد التكنولوجيّ باعتباره الثّورة الصّناعيّة في مرحلة النّضج المرعب وغائيّة هذه اللّحظة منذ أن اُسْتُخْرِج الفحم لأوّل مرّة ومعالجة الحديد لأوّل مرّة.
“تتناول القصيدة موضوع التّقادم ومدى سرعة تغيّر الأشياء مع ظهور التّقنيات الجديدة،” بهذا أخبرني تشات دجي.بي.تي.-3، بعد تسجيل الدّخول إلى الموقع والتّأكيد أنّني لست روبوتا. لقد فكّرت في تحدّيه في مسابقة أدبيّة نقديّة، إلاّ أنّني ذهبت إلى ما هو أفضل. فكّرت أنّ القراءة، تلك التّجربة الحقيقيّة – التّمييزيّة والفرديّة والذّاتيّة والشّخصيّة – هي فعل إبداعيّ متساو. وعندما يتمّ ذلك بصدق، يبدع القارئ جنبا إلى جنب مع الكاتب، ولا يستطيع تشات دجي.بي.تي.-3 أن يقرأ حقّا، ليس حقّا. إنّما الإبداع عمليّة وليس منتجا. يستطيع تشات دجي.بي.تي.-3 أن يجترّ المواضيع، وربّما يسبر غور الدلّالات بأقصى ما في وسعه، إلّا أنّه لم ير أبدا مداخن قاري والمصانع المغلقة في ديترويت وبيسمر المهجورة في بيتسبرغ وأكوام خام المعادن في برادوك. وأيّا كان مصدر الكلمات التي نحلّلها، إنسانا كان أم آلة، فإنّنا في آخر المطاف نقرأ بعيون بشريّة. إنّه لعزاء ضئيل ووهم صغير أنّ القارئ والنّاقد هما كلّ ما نحتاجه لدحر الرّوبوت؛ وأنا أختار أن أصدّق ذلك. وقد نستطيع أن ننسحب ونحن مطمئنّون إلى أنّنا حتّى لو خسرنا المنافسة، فإنّ قلوبنا لن تنكسر أبدا.
رابط المقال الأصلي: On AI, Authorship, and Algorithmic Literature
تأليف: إد سايمون